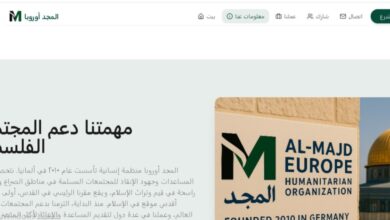خطيئة السلطة والثقة في ترتيبات “اليوم التالي” للحرب المفروضة إسرائيليا

تعيش السلطة الفلسطينية اليوم في فلك من الأوهام السياسية، تُقنع نفسها بأنّها شريك موثوق في ترتيبات “اليوم التالي” للحرب على قطاع غزة، وأنّ دعمها لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثم موافقتها على قرار مجلس الأمن 2803، سيعيد إليها دورًا مفقودًا منذ ما يقارب عقدين في القطاع.
ويؤكد مراقبون أن هذا الوهم لا يستند إلى أي قراءة واقعية، لا في نوايا واشنطن، ولا في الحسابات الإسرائيلية، ولا في مزاج الشعب الفلسطيني الذي فقد الثقة بالسلطة منذ زمن طويل.
فمن غير المفهوم كيف تصوّرت السلطة أنّ خطة ترامب – وهي الخطة الأكثر عدائية تجاه الحقوق الفلسطينية منذ أوسلو – يمكن أن تكون بوابة لعودتها إلى غزة.
والأخطر أنّ بعض قيادات “فتح”، اعتبرت القرار الأممي الجديد “اعترافًا دوليًا” بقدرة السلطة على إدارة الإعمار في القطاع وذلك في تفسير ساذج يكشف عمق الانفصال بين السلطة والواقع، ويعكس انجرارًا وراء رسائل غربية خادعة توحي بأنّ العالم اختار السلطة بديلاً عن حركة حماس، بينما الحقيقة أكثر تعقيدًا وشراسة بكثير.
فالسلطة تبني أوهامها على قراءة سطحية لكل من خطة ترامب والموقف الأوروبي.
صحيح أنّ الاتحاد الأوروبي يلمّح إلى دعم دور مستقبلي للسلطة في غزة والضفة، لكن هذا الدعم ليس سياسيًا، ولا هو تثبيت لشرعية وطنية فلسطينية، بل هو اشتراط وابتزاز: وقف المقاومة، واقتلاع الخطاب الوطني، وتنفيذ ما تُسمّيه واشنطن “إصلاحات” هدفها الوحيد محو الذاكرة التاريخية الفلسطينية من المناهج والإعلام والثقافة.
السلطة الفلسطينية ويكيبيديا
الثابت أن واشنطن لم تكن يومًا معنية بإصلاح خدمات السلطة أو محاربة فسادها.
فالمطلوب أميركيًا هو سلطة منزوعٌ منها أي بُعد وطني، سلطة تُشرف على الفلسطينيين لا باعتبارهم شعبًا، بل باعتبارهم مجتمعات خاضعة للضبط والسيطرة، مسالمة بما يكفي لإنجاح المخططات الأميركية الصهيونية.
وهنا تكمن خطيئة السلطة: أنّها قبلت أصلاً بهذا الدور، ثم فشلت فيه، وأظهرت لإسرائيل والولايات المتحدة أنّها غير قادرة على منع ظهور المجموعات المقاومة، أو محو مفاهيم الشهادة والتحرير من الخطاب الشعبي.
والأمر يتجاوز السلطة نفسها، فالمخاطر الناتجة عن أوهامها تنعكس على القضية الفلسطينية برمّتها.
فترامب، الذي يسعى لتشكيل مجلس وصاية استعماري لإعادة هندسة غزّة ديموغرافياً وجغرافيًا، لا يرى مكانًا لسلطة فلسطينية إلا بعد إعادة تشكيل القطاع وفق مقاسات الاحتلال والمستثمرين الدوليين.
أي أن دور للسلطة في “غزة الجديدة” سيكون دورًا إداريًا وشرطيًا، لا وطنيًا، بعد أن تُنجز عملية “غربلتها” سياسيًا وفكريًا دون تحديد أي سقف زمني لذلك.
وما يزيد الوهم عمقًا أنّ دولة الاحتلال ترفض أصلًا أي دور للسلطة في غزة، وتعمل في الضفة الغربية على تقليص الأراضي الواقعة تحت إشرافها، تمهيدًا لضمّها الفعلي وهذا وحده كاف لنسف التصوّر الساذج للسلطة بأنّ واشنطن أو تل أبيب تريدان لها دورًا مستقبليًا.
البقاء الشكلي للسلطة خدمة للاحتلال
الملاحظ أن بعض الدول العربية تتمسّك شكليًا ببقاء السلطة ليس حبًا بها، بل خشية فراغ سياسي قد يعقّد المشهد الإقليمي، أما الفلسطينيون فيخشون انهيار المنظمة وغياب أي تمثيل دولي، لا لأنهم يؤمنون بالسلطة، بل لأن البديل غير واضح.
لكن هذا الوعي الشعبي يحمي السلطة من السقوط، وهو ما لم تفهمه القيادة بعد. فهي تعتقد أن الصبر عليها دليل شرعية، بينما الحقيقة أنّ الفلسطينيين يتمسكون بالحد الأدنى من الهيكل السياسي فقط لمنع تمرير مخطط تصفية القضية.
والولايات المتحدة تدرك ذلك، ولذلك تريد “نسخة جديدة” من السلطة، أكثر قابلية للسيطرة، وأقدر على تنفيذ مقررات خطة ترامب: تغيير المناهج، ضبط الجامعات، خنق الصحافة، منع التحرك القانوني الدولي، وتحييد أي تعبير ثقافي أو تربوي يتصل بفلسطين المقاومة.
الأخطر أنّ واشنطن لا تريد بقاء السلطة بشكلها الحالي. هي تحتاجها مؤقتًا فقط لمنح غطاء شرعي للخطط الأميركية-الإسرائيلية في غزة والضفة، وبعدها سيُستكمل مسار تفكيكها، إلى أن تغدو مجرد جهاز إداري يخلو من أي صفة سياسية أو وطنية.
لهذا كلّه، فإنّ تمسّك السلطة بأوهام “الدور المستقبلي” ليس مجرد خطأ سياسي، بل هو تواطؤ غير مباشر في مخطط تصفية القضية. المشكلة ليست في شعار “فلتسقط السلطة”، بل في أن القرار لا يزال مرتهنًا لقيادة غير موحدة. المطلوب قيادة وطنية فلسطينية شاملة تواجه السلطة نفسها بإرادة الشعب، وتوقف اندفاعها وراء سراب “اليوم التالي”.
فالقضية ليست تنافسًا بين الفصائل، بل صراع على وجود الشعب الفلسطيني وهويته وحقه في أرضه. ومن دون وعي سياسي جديد يقلب المعادلة، ستبقى السلطة أسيرة أوهامها، بينما تُستكمل على الأرض عملية تصفية القضية الفلسطينية.