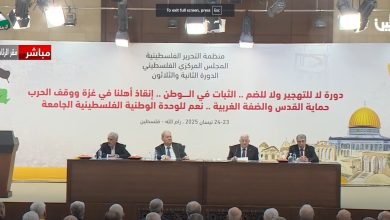فساد السلطة الفلسطينية يدفع ثمنه الفئات الأكثر هشاشة
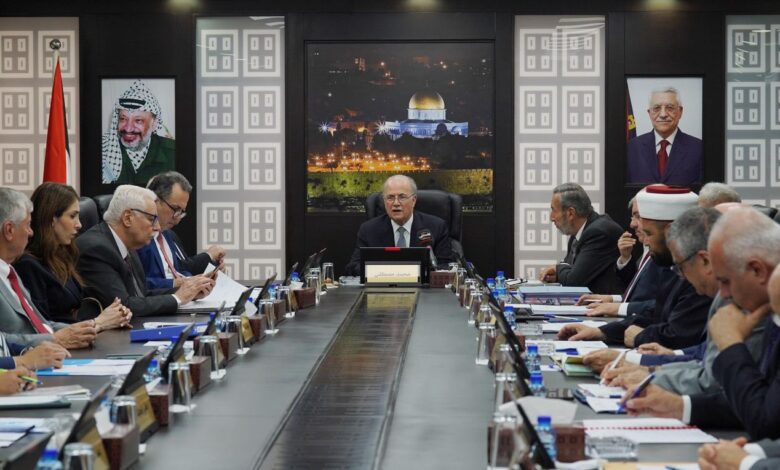
تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى السلطة الفلسطينية في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وسط اتهامات مباشرة بأن الفساد وسوء الإدارة يضاعفان معاناة الفئات الأكثر هشاشة، ويدفعان بها إلى واجهة الانهيار المعيشي، في وقت يُفترض فيه أن تكون هذه الفئات أولوية في السياسات العامة لا ضحية لها.
وبحسب تقارير ودراسات محلية، تتحمل السلطة مسؤولية قانونية وأخلاقية في ضمان تقديم الخدمات الأساسية بشكل عادل ودون تمييز، لا سيما للأسر الفقيرة، والنساء، وذوي الإعاقة، والتجمعات البدوية، وسكان المناطق المحاذية للمستوطنات، التي تواجه خطر الاقتلاع والتهجير القسري.
غير أن الواقع على الأرض يكشف عن فجوة متسعة بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية، حيث تُترك هذه الفئات لمواجهة أزمات مركبة دون حماية حقيقية أو سياسات واضحة تعزز صمودها.
ويشير مختصون في الشأن الاقتصادي والاجتماعي إلى أن العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكدين أن استمرار الهدر المالي وغياب المساءلة داخل مؤسسات السلطة ينعكس مباشرة على الفئات الأضعف.
فبدل توزيع الأعباء بشكل عادل، تتحول الأزمات المالية إلى أداة ضغط إضافية على الفقراء، الذين يتحملون العبء الأكبر من السياسات الضريبية غير المنصفة، في حين تبقى مراكز النفوذ بعيدة عن المحاسبة.
فساد السلطة الفلسطينية
تبرز أزمة أموال المقاصة بوصفها أحد أخطر التحديات التي تعمّق هذا الواقع. إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، حيث تجاوزت الاقتطاعات 4.4 مليار دولار خلال عشرة أشهر فقط، ما أدى إلى تراكم ديون على السلطة الفلسطينية بلغت نحو 15.4 مليار دولار.
غير أن مراقبين يؤكدون أن الفساد الداخلي وسوء إدارة الموارد فاقما من تداعيات هذه الأزمة، وحوّلاها من ضغط خارجي إلى كارثة اجتماعية داخلية.
وانعكست الأزمة بشكل مباشر على رواتب موظفي القطاع العام، التي جرى صرفها بنسبة لا تتجاوز 60% وبحد أدنى 2000 شيكل، وهو ما أدخل آلاف العائلات في دوامة العجز عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
ولم يقتصر التأثير على الموظفين، بل امتد إلى أسر الشهداء والأسرى والجرحى، الذين يعتمدون على مخصصات شهرية باتت غير كافية لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم.
كما تضررت برامج التحويلات الاجتماعية التي تشكل شبكة الأمان الأخيرة للأسر الفقيرة، في وقت تشهد فيه معدلات البطالة والفقر ارتفاعاً غير مسبوق.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن النساء والشباب وذوي الإعاقة كانوا من بين الأكثر تضرراً، إذ يعتمد كثير منهم على الإنفاق الحكومي المباشر أو غير المباشر، ما يجعل أي تقليص في الموازنات بمثابة ضربة قاسية لاستقرارهم المعيشي.
مسئوليات السلطة في ظل الأزمة المعيشية
في مواجهة هذا الواقع، يُعاد طرح مفهوم “اقتصاد الصمود” في الدراسات الفلسطينية كخيار للبقاء في ظل الاحتلال، من خلال دعم الزراعة، وتشجيع المشاريع الصغيرة، وتقليل التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
ويؤكد باحثون أن هذا المفهوم متجذر في التجربة الفلسطينية منذ عقود، وارتبط تاريخياً بالصمود على الأرض ومواجهة سياسات التهجير منذ النكبة وحتى اليوم.
غير أن الواقع الحالي، وفق هذه الدراسات، يكشف أن ما يجري هو في كثير من الأحيان إدارة أزمة للبقاء لا مسار تنمية حقيقي. فغياب الرؤية الاقتصادية، واستشراء الفساد، واستمرار ثقافة الاستهلاك والاعتماد على المساعدات، كلها عوامل تفرغ “اقتصاد الصمود” من مضمونه، وتحوله إلى شعار سياسي لا يلامس حياة الناس.
ويجمع مراقبون على أن استعادة الثقة الشعبية تتطلب تحولاً جذرياً في نهج السلطة، يبدأ بمكافحة الفساد بجدية، ويمر بوضع سياسات ضريبية عادلة، وينتهي بإعادة الاعتبار للأرض والإنتاج المحلي، وبدون ذلك، ستبقى الفئات الأكثر هشاشة هي الخاسر الأكبر، وستظل تكلفة الفساد تُدفع من قوت الفقراء، لا من جيوب الفاسدين.