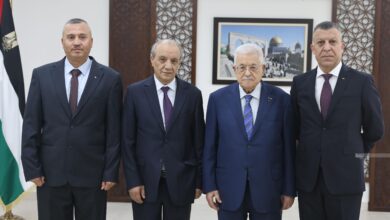التحذيرات من المجاعة في غزة تصل ذروتها وسط تواطؤ دولي

تصل التحذيرات من مخاطر المجاعة في غزة ذروتها في وقت تقول الأمم المتحدة إن المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع متوقفة في الغالب خلال الشهرين الماضيين غير أن كل ذلك يجابه بصمت وتواطؤ دولي صارخ.
وأعلنت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة في ل تواصل حملة تطهير عرقي إسرائيلية منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024 توقفت إلى حد كبير خلال الأيام الستة والستين الماضية.
وأدى ذلك إلى حرمان ما بين 65 و75 ألف فلسطيني من الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والرعاية الصحية، وفقا للمنظمة الدولية.
وفي الشمال، واصلت دولة الاحتلال الإسرائيلي حصارها على بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، حيث حرم السكان إلى حد كبير من المساعدات، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وبالإضافة إلى أزمة الغذاء، لا تعمل في قطاع غزة سوى أربعة مخابز تدعمها الأمم المتحدة، وجميعها في مدينة غزة، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وقالت سيغريد كاغ، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، للصحفيين بعد إحاطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلف أبواب مغلقة إن المدنيين في غزة يواجهون “وضعا مدمرا للغاية”.
وقد أدى انهيار القانون والنظام بفعل الهجمات الإسرائيلية وتشجيع الاحتلال عصابات النهب إلى تفاقم الوضع المزري وترك الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة غير قادرة على توصيل الغذاء لمئات الآلاف من الفلسطينيين المحتاجين.
“أسوأ من أي وقت مضى”
في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، أفاد مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين أنطوان رينارد بأن “مستويات الجوع والدمار والخراب في غزة الآن أسوأ من أي وقت مضى”.
وأضاف أن الأسواق خاوية، ولا يصل إليها أي طعام تقريبًا، وأن الظروف الجوية المتدهورة تجبر الناس على “النضال اليومي من أجل البقاء”.
ولا تزال عمليات النهب والهجمات على القوافل الإنسانية تضغط على توصيل المساعدات في جنوب ووسط غزة، في حين لا تزال المحاولات المستمرة من جانب شركاء قطاع الأمن الغذائي لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى المناطق المحاصرة في شمال غزة محظورة إلى حد كبير بعد 60 يومًا من الحصار المشدد.
وحتى التاسع من ديسمبر/كانون الأول، لم يتبق سوى أربعة مخابز من أصل 19 مخبزًا يدعمها برنامج الأغذية العالمي تعمل في جميع أنحاء قطاع غزة، وكلها في محافظة غزة حيث كان تدفق دقيق القمح ثابتًا بشكل عام وسعر كيس الدقيق الذي يبلغ وزنه 25 كيلوغرامًا حوالي 20-30 شيكلًا (5.6-8.4 دولارًا أمريكيًا).
ويأتي هذا على النقيض من الوضع في وسط وجنوب غزة، حيث أشارت ملاحظات السوق إلى أن سعر كيس الدقيق بلغ 1000 شيكل (280 دولاراً أميركياً) على الأقل في الأول من كانون الأول/ديسمبر في دير البلح، و875 شيكل (245 دولاراً أميركياً) في خان يونس.
وقد ساهمت كل من العوائق التي تحول دون الوصول إلى الغذاء، والهجمات الإسرائيلية المستمرة، والافتقار شبه الكامل للسلع التجارية الداخلة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية القليلة المتاحة في السوق في تدهور التنوع الغذائي في مختلف أنحاء القطاع.
ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني، هيمن الخبز والبقول على الأنظمة الغذائية للأسر للشهر الثاني على التوالي، مع عدم استهلاك الخضراوات واللحوم والبيض تقريباً.
وفي الفترة ما بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني و6 ديسمبر/كانون الأول، أجرت اليونيسف مسحاً جديداً لرصد ما بعد التوزيع، أظهر أن ما يقرب من 100% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و23 شهراً والنساء الحوامل والمرضعات في مدينة غزة ودير البلح وخان يونس لا يستوفون الحد الأدنى من التنوع الغذائي، والذي يُعرَّف بأنه تلقي أغذية من أربع مجموعات غذائية على الأقل من أصل سبع مجموعات غذائية.
يسلط تحليل نشرته مجموعة الحماية، بدعم من FSS، الضوء على أن “الأطفال والنساء يبحثون الآن بشكل متزايد في أكوام القمامة عن بقايا الطعام”، وغالبًا ما يكونون حفاة الأقدام وبدون قفازات، ويواجهون مخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض والإصابات من الحواف الحادة أو المعدن في النفايات الصلبة ويتعرضون بشدة لخطر الذخائر غير المنفجرة.
كما أدى تقلص إمدادات الغذاء إلى إثارة العنف الجسدي في المخابز ونقاط التوزيع التي لا تزال تعمل، حيث قُتلت ست نساء وفتيات حتى 2 ديسمبر في حوادث تدافع اندلعت أثناء انتظارهن الخبز في المخابز.
كما يتزايد الاعتماد على استراتيجيات التكيف السلبية، بما في ذلك عمالة الأطفال والتسول، بينما أفاد شركاء العنف القائم على النوع الاجتماعي أن النساء والفتيات يمارسن الجنس من أجل البقاء مقابل الطعام، مما يزيد من تعرضهن للاستغلال والإساءة.
“لقد تُركت النساء والفتيات في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك 50 ألف امرأة حامل، بدون الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة”، بحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان الضوء على ذلك.
وتستمر الوفيات بين الأمهات والإجهاض والولادات المبكرة في الارتفاع، مع كون الظروف حرجة بشكل خاص في المناطق المحاصرة في محافظة شمال غزة، حيث ظل ما يقدر بنحو 1720 امرأة حامل وفتاة مراهقة معزولات إلى حد كبير عن المساعدات الأساسية لأكثر من 60 يومًا.
وأدت الهجمات المتكررة والأضرار التي لحقت بمستشفى كمال عدوان، آخر منشأة رئيسية تقدم رعاية الأم والوليد في المحافظة، إلى إعاقة وصول النساء الحوامل إلى الرعاية الحرجة، حيث توفي الأطفال حديثي الولادة “بسبب نقص الحاضنات والكهرباء والإمدادات الطبية”.
وفي الوقت نفسه، لجأ ما يقدر بنحو 90 ألف امرأة وفتاة – أو حوالي 70 في المائة من السكان النازحين من شمال غزة منذ تكثيف الهجمات الإسرائيلية في أكتوبر 2024 – إلى ملاجئ مكتظة ومبانٍ متضررة في مدينة غزة، ويكافحون من أجل الوصول إلى خدمات متزايدة التوتر.